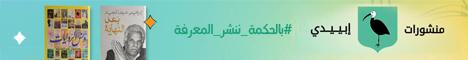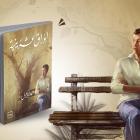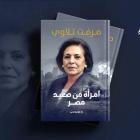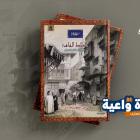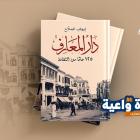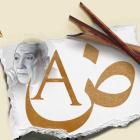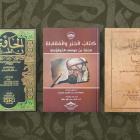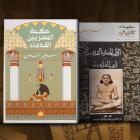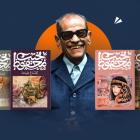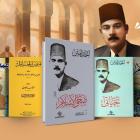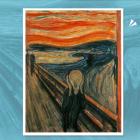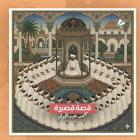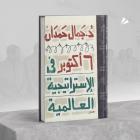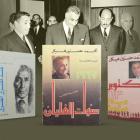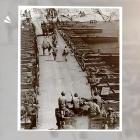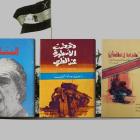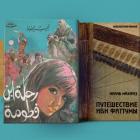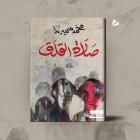معرفة
قوة الجغرافيا في إيران: ذاكرة الحجر وحدود النار
إيران بين الجبال والنفط والهوية: كيف صنعت الجبال والصحارى والسياسة ملامح إيران المعاصرة؟
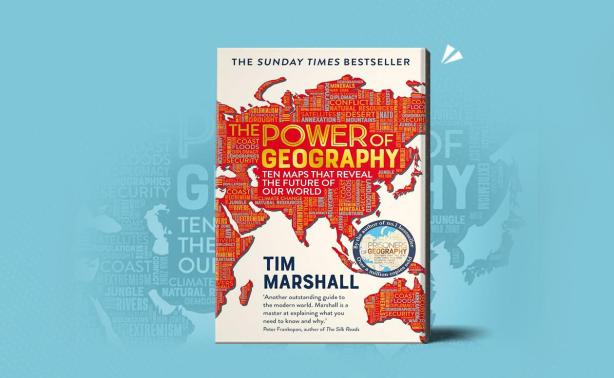 غلاف كتاب The Power of Geography: Ten Maps That Reveal the Future of Our World
غلاف كتاب The Power of Geography: Ten Maps That Reveal the Future of Our World
هذا كتاب شيّق لغير المتخصصين في الجغرافيا السياسية، وضعه تيم مارشال، الكاتب البارع، صاحب القدرة على تلخيص الأفكار الجغرافية والتاريخية بشكل مبسّط للقارئ غير المتخصص. في هذا الكتاب، يُقدِّم المؤلف عشر خرائط يمكن بها فَهم الصراعات التي تُشكِّل عالمنا وتندلع بسببها الحروب التي تُهلِك البشر.
وفي المقال الحالي اخترت أن أَعرض للفصل الثاني الذي يتناول فيه المؤلف خريطة إيران بالشرح التاريخي، مع تحليل موقفها الجيوسياسي.
الجغرافيا العسكرية
يتميّز سطح الأرض في إيران بمعلمين رئيسين:
- الجبال التي تُشكِّل حلقة دائرية تُحيط بالبلاد من كل ناحية وتُمثِّل حدودًا طبيعية حامية من الغزو البري؛
- الصحاري الداخلية شبه المنبسطة الجافة والمالحة، والتي هي في حقيقتها تُمثِّل جزءًا مكمِّلًا لتضاريس الجبال، لكن هنا تُعدّ مَلمحًا من التلال والسهول المرتفعة. وأشهر الصحاري هنا صحراء لُوط في الجنوب والوسط، والصحراء الملحّة الكبرى في الشمال.
تبدأ جبال زاغروس من ساحل مضيق هرمز في جنوب غرب البلاد، قبالة قطر والمملكة العربية السعودية عبر الخليج العربي (الذي تُسمّيه إيران الخليج الفارسي)، ثم تتجه شمالًا على طول مجرى شط العرب قبالة العراق، صعودًا على الحدود البرية مع العراق وتركيا، قبل أن تتجه جبال زاغروس شمالًا بشرق على طول الحدود مع أرمينيا.
حيث تنتهي جبال زاغروس، تبدأ جبال البرز في السيطرة على المشهد إلى الجنوب من بحر قزوين. وقد تأسست العاصمة طهران هنا: أسفل جبل البرز جنوب قزوين.
يبلغ طول ساحل بحر قزوين ما يتجاوز 600 كم، وتُحيط به جبال يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر، ولا تترك بينها وبين ساحل بحر قزوين أكثر من ٥٠ كم.
وفيما وراء قزوين شرقًا، تمتد الجبال أيضًا على طول حدود تركمانستان وأفغانستان، ثم تتناقص في منسوبها في جنوب شرق البلاد عند خليج عمان، فتلتقي بسلسلة جبال مكران الوسطى، ومنها إلى مضيق هرمز.
وهذا الجدار الجبلي الذي يمتدّ لأكثر من 1500 كم يصنع من إيران قلعة حصينة ترددت كل القوى الأوروبية الحديثة في مغامرة العدوان عليها.
الاستثناء الوحيد في قلعة إيران الجبلية هو مجرى شط العرب المائي، حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات على الجانب العراقي من الحدود. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المدخل بالضرورة نقطة ضعف لإيران، لأنه من زاوية أخرى يُمثّل البوابة الرئيسية لخروج إيران إلى العالم الجنوبي في الخليج، ومن خلفه المحيط الهندي والبحر الأحمر.
لا يختلف أحد على توصيف إيران بأنها واحدة من أهم القوى في الشرق الأوسط، وإن كانت صورتها تختلف باختلاف الدوائر الجغرافية الإقليمية والعالمية، فبعض الدوائر الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية تصف نظامها بالقمعي، ورعاية الإرهاب، وسفك الدماء في جميع أنحاء المنطقة.
وفي الشؤون العسكرية، تُوصَف إيران بأنها دولة شبه نووية أو على مرمى حجر من امتلاك السلاح النووي، وهو ما يُمثّل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل. وإيران مرشحة دومًا لتلقّي غزو أمريكي دون أن يحدث ذلك، لأن واشنطن في تردد دائم من المواجهة مع إيران. وبالطبع لا يفكرون في إرسال أي قوات إلى إيران لطبيعتها الجغرافية والاستراتيجية وقلعتها الجبلية.
قبل ربع قرن، تزعم الصقور في إدارة جورج دبليو بوش حملة لضرب إيران، لكن وزير الخارجية كولن باول قال إن القوة الجوية وحدها ستكون ذات نجاح محدود، وأن الحرب التي ستلي الضربات الجوية لا بد لها من إنزال بري وبحري، وهو أمر بالغ المخاطرة.
طيلة تاريخ إيران، كان اسمها الذي تُعرَف به بلاد فارس. ولم تُغيِّر اسمها إلى إيران إلا عام 1935، في محاولة لتمثيل الأقليات غير الفارسية في البلاد، والتي تُشكِّل حوالي 40٪ من سكانها.
الشعب.. الأعراق واللغات
ترك التركيب التضاريسي أثره على سكان البلاد، فطبيعة البلاد القاحلة والقاسية كانتا سببًا في استيطان معظم الإيرانيين في الجبال. وليست كل الجبال سهلة في السُّكنى، ويَبقى معظمها غير مأهول. وكان من نتائج ذلك أن نزعت الجماعات السكانية المستوطنة في الجبال إلى تطوير ثقافات مميّزة، وتتمسك الجماعات العِرقية بهويّاتها وتُقاوم الاندماج، مما يُصعِّب على الدولة الحديثة تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية.
وبسبب هذه الطبيعة الجبلية، تتناثر المراكز السكانية الرئيسية في إيران على نطاق واسع، وإلى وقت قريب، كانت إيران ضعيفة الترابط. وإلى اليوم لا تتجاوز نسبة الطرق المعبّدة في البلاد 50٪.
يُوصَف كل من يعيش في إيران بأنه إيراني، إلا أنهم ينتمون إلى جماعات عِرقية مختلفة، فيتحدث حوالي 60٪ من الإيرانيين اللغة الفارسية كلغة أولى، وهي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية. وهناك حضور لغوي وإثني متنوّع للجماعات العِرقية مثل: الأكراد، والبلوش، والتركمان، والأذربيجانيين، والأرمن، والعرب، والشركس، والجورجيين.
وعبر القرون، تسبب هذا التنوّع الكبير في المجموعات العِرقية في مشكلات كبيرة للسلطة المركزية، ومن بينها الحيلولة بكل الطرق – ومن بينها القمع القسري – للإبقاء على الأقليات العِرقية تحت السيطرة، وضمان عدم قدرة أي منطقة جغرافية منها على الانفصال أو تلقّي مساعدة من القوى الخارجية.
يُعَدّ الأكراد (بنحو 10٪ من سكان البلاد) أبرز الأمثلة على تمسّك سكان الجبال بثقافتهم في وجه سياسات الدولة الإدماجية القسرية. يعيش معظم الأكراد الإيرانيين في جبال زاغروس المجاورة لأكراد العراق وتركيا، والذين يتشاركون معهم حلم إقامة دولة كردية مستقلة. والأكراد ثاني أكبر أقلية بعد الأذريين (16٪).
ولمئات السنين تتفاقم مشكلة الأكراد أكثر من غيرها، ليس فقط لأنهم مختلفون عِرقيًّا، بل أيضًا لأنهم على المذهب السُّني في دولة ذات أغلبية شيعية. وقد استغرق الجيش الإيراني ثلاث سنوات لقمع انتفاضتهم الأخيرة، التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.
ويتمركز الأذربيجانيون في المناطق الحدودية الشمالية بالقرب من أذربيجان وأرمينيا، ويعيش التركمان بالقرب من الحدود التركمانية، أما العرب، الذين يبلغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة، فيتجمعون بالقرب من مجرى شط العرب قبالة العراق، وعلى جُزر صغيرة في الخليج.
موارد المياه
يُعدّ نقص المياه أحد العوامل العديدة التي أعاقت نموّ إيران الاقتصادي. وجراء نقص المياه، تأسست كثير من المدن الإيرانية عند سفوح التلال، كي تحصل على إمداداتها من المياه من أنفاق محفورة على سفوح الجبال تُغذّي قنوات صغيرة تنحدر إلى المناطق الحضرية.
لا تزيد نسبة الأراضي المزروعة في إيران عن 10٪ من إجمالي مساحتها، إذ لا تتلقى أكثر من ثلث أراضيها مياه للري. ولا يوجد في إيران سوى ثلاثة أنهار كبيرة، أهمها الكارون في غرب البلاد (في اتجاه شط العرب)، وهو الصالح وحده للملاحة، وقادر على نقل البضائع.
لكن التقدّم التكنولوجي، ولا سيما النقل الجوي، عزّز التجارة الداخلية والخارجية، حيث تنتشر المطارات الدولية في طهران، وبندر عباس، وشيراز، وعبادان، وأصفهان. وفي بلدٍ مثل إيران – أكبر في مساحته من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا مجتمعةً – يُعدّ النقل الجوي أفضل وسيلة للتواصل الفعّال في هذه البلاد الجبلية والصحراوية ذات المراكز المتفرّقة للاستيطان البشري، والواقع معظمها في النصف الغربي للبلاد.
الثروة وموارد الطاقة
تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتقع معظم الحقول النفطية في المناطق المواجهة للمملكة العربية السعودية والكويت والعراق، مع حقل أصغر في الداخل بالقرب من قم في الشمال الغربي. أما حقول الغاز فتقع في جبال البرز في الشمال وفي الخليج العربي في الجنوب الغربي.
وبناء على هذه الثروات المتعددة كان من المفترض أن تكون إيران دولة غنية؛ إلا أن الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) تسببت في تدمير البنية الأساسية ولا سيما منشآت التكرير في عبادان، ولم يستعد الإنتاج مستوياته إلا بعد ربع قرن من نهاية تلك الحرب.
ويعتبر مضيق هرمز أحد طرق التصدير الرئيسية مع خليج عمان. وهرمز هو السبيل الوحيد لإيران للخروج إلى ممرات المحيط المفتوحة. وفي أضيق نقطة يبلغ عرض المضيق 30 كم. بل إن ممر الشحن في كلا الاتجاهين لا يزيد عن 3 كم. مع وجود منطقة عازلة بينهما بعرض ميلين لتجنب الحوادث.
ومضيق هرمز بالنسبة لإيران سلاح ذو حدين.، تعبر من خلاله 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو من ناحية أحد الأسباب التي حالت دون أن تصبح إيران قوة بحرية واعدة عبر التاريخ، لأن الأعداء بوسعهم حبسها داخل المضيق ومنعها من الوصول إلى المحيط. لكن على الجانب الآخر فإن عرض المضيق المحدود يعطي لإيران ميزة حصرية تهدد فيها بإغلاقه أمام أي طرف معاد لها.
تتدرب القوات الإيرانية بشكل متكرر على قدرتها على الهجوم على السفن الكبيرة، مستخدمةً عشرات الزوارق الهجومية السريعة، بعضها مُجهز بصواريخ مضادة للسفن. في حال نشوب صراع شامل، قد تستخدم إيران أيضًا فرقًا انتحارية، كما فعلت خلال الحرب الإيرانية العراقية. علاوة على قدرتها على تفخيخ ناقلات النفط وتلغيم مياه الخليج مما سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وربما ركود عالمي، وعادة ما تكون إيران قريبة من ذلك الخيار في حال تعرضها لتهديد وجودي أو حصار اقتصادي حاد.
من جانبهم يتدرب الأمريكيون على خطط متقدمة للقضاء على أكبر قدر ممكن من القدرات الهجومية الإيرانية في غضون ساعات من اندلاع صراع كبير. وفي سلوك تطويقي تبني دول الخليج خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز إلى البحر الأحمر، على الجهة الغربية من الصراع، وحتى في هذه الجهة تبقى السفن عرضة لإطلاق صواريخ الحوثيين: حلفاء إيران في اليمن.
تاريخ مضطرب في الماضي والحاضر
إيران الحديثة أمة مضطربة، لكنها ذات تاريخ عريق، حازت فارس شهرة قديمة في العقل الأوروبي منذ حروبها الطويلة مع أثينا، وظلت مصدر الخطورة على أوروبا إلى أن أحرز الإسكندر الأكبر تقدمًا وأنزل بفارس هزيمة كبيرة.
لكن فارس عادت تسيطر على شؤونها الخاصة بعد ذلك لقرون طويلة قبل أن تنكسر في هزائم مروعة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر أمام الغزاة المغول ودمروا البلاد وسفكوا دماء مئات الآلاف من الناس، لكنهم لم يبقوا طويلًا بما يكفي للتأثير بشكل كبير على الثقافة الفارسية.
كما غامر العثمانيون بدخول جبال زاغروس عدة مرات بدءًا من القرن السادس عشر، لكنهم لم يتجاوزوا التخوم الخارجية. وحاول الروس فعل الشيء نفسه، ثم وصل البريطانيون وقرروا أن أفضل رهان هو استقطاب بعض الأقليات وشراء طريقهم للنفوذ.
ويمكن تقسيم رحلتها عبر الزمن في المحطات التالية:
- قبل أربعة آلاف عام
كانت الإمبراطورية الفارسية حضارةً رائدةً في العالم القديم. للتاريخ الإيراني تاريخ مماثل في المجد والعظمة والدموية، كما هو الحال في اليونان، لذا ليس من المستغرب أن تصطدم الحضارتان، أو أن تصطدم بلاد فارس مع روما.
تعود أصول الفرس إلى ما يقرب من أربعة آلاف عام، مع هجرة القبائل المرتحلة من آسيا الوسطى ليستقروا في جبال زاغروس الجنوبية.
في عام 550 ق.م. استولى القائد الفارسي قورش الثاني على مملكة الميديين المجاورة، ودمجها مع الإمبراطورية الفارسية، وأعلن عن بروز الإمبراطورية الفارسية الأخمينية على الساحة العالمية.
أسس قورش أعظم إمبراطورية عرفها العالم، ممتدةً عبر بلاد ما بين النهرين (العراق وسوريا حاليًا) وصولًا إلى اليونان، قبل أن تسقط بموته في عام 529 ق.م. خلف كورش ابنه (قمبيز الثاني)، الذي ضمّ مصر وأجزاءً مما يُعرف الآن بليبيا إلى الإمبراطورية لكنه لم يعمر طويلا، وبزغ من بعده (داريوس) في عام 522 ق.م. الذ وسّع حدود الإمبراطورية إلى أجزاء مما يُعرف الآن بباكستان وشمال الهند، وصولاً إلى وادي الدانوب في أوروبا.
خلال حكم داريوس على الشرق الأدنى سمح لليهود في فلسطين القديمة بإعادة بناء الهيكل في القدس، وشجّع على نشر المعتقدات الدينية الزرادشتية.
وفي عهده أُنشئت أول خدمة بريدية في العالم عبر شبكة من خيول النقل، ونفّذ مشروع ضخم شمل طرقًا معبدة تمتد لآلاف الأميال.
لم تكن كل الأمور على ما يرام بالنسبة لداريوس. فقد انزعج من بعض المدن اليونانية لعدم إظهارها الاحترام الكافي (أو دفع أموال الحماية له)، فغزا البر الرئيسي لليونان. لكن الأمور سارت على نحو خاطئ بعض الشيء في معركة ماراثون عام 490 ق.م.، والتي حققت انتصارًا ساحقًا لليونانيين.
توفي داريوس بعد أربع سنوات وخلفه ابنه زركسيس، الذي خسر أيضًا أمام اليونانيين، مما يمثل بداية نهاية الإمبراطورية الفارسية الأولى. أطلق كورش وداريوس على نفسيهما اسم العظيم، لكن إمبراطوريتهما دُمرت على يد اسم أكبر - الإسكندر الأكبر المقدوني - في عام 331 ق.م. حين أنزل بالجيش الفارسي هزيمة شاملة.
- ما بعد الإسكندر الأكبر
استغرق الأمر قرابة مئة عام قبل أن تنهض الإمبراطورية الفارسية التالية. وفيما بعد حارب البارثيون الإمبراطورية الرومانية للسيطرة على بلاد ما بين النهرين ومنعها من دخول بلاد فارس من الشمال، وتحديدًا تركيا وأرمينيا. وتُوِّج هذا بانتصار في عام 53 ق.م.
بعد حوالي 250 عامًا، أطاح الساسانيون بالفرثيين من الداخل وواصلوا محاربة روما، ثم الإمبراطورية البيزنطية، تاركين إياهم منهكين وعرضةً للتحدي التالي، القادم إلى فارس من الغرب: العرب والإسلام.
- العرب يسقطون فارس
صعد الإسلام من جزيرة العرب وأنزل هزيمة بالفرس، كانت هزيمة الساسانيين في القرن السابع نتيجة ضعف سياسي غير مسبوق وهزيمة على يد عدوٍّ مُشرق بنور دين جديد.
خسرت بلاد فارس منطقتها العازلة في بلاد ما بين النهرين، ثم معظم أراضيها الداخلية. ومع ذلك، استغرق العرب عشرين عامًا للاستيلاء على المناطق الحضرية؛ ولم يسيطر العرب مطلقا على الجبال، وكانت هناك انتفاضات متكررة ضدهم.
في النهاية، خسر العرب السيطرة على فارس من الناحية الجغرافية، لكن المدهش أن الإسلام انتصر!
لقيت الزرادشتية هزيمة قاسية على يد الإسلام وتم التخلص من كهنتها، وأصبح الإسلام الدين السائد. أُدمجت بلاد فارس في الخلافة، لكن اتساع مساحتها وقوة ثقافاتها استعصى على اندماجها، وظلت تفكر دائمًا في حدودها مع الغرباء. وقد تفاقم هذا الوضع بعد عدة قرون، عندما اعتنقت بلاد فارس المذهب الشيعي.
قبل ذلك، شهد فارس موجات هجرة للغزاة الترك والمغول. ومرة أخرى، جاء الغزو بعد انهيار السلطة المركزية وتقسيم بلاد فارس إلى ممالك صغيرة. ولم تسترد البلاد قوتها في حكم نفسها والدفاع عن حدودها إلا بعد أن وحّدها الصفويون (1501-1722).
- الدولة الصفوية
يُمثل الصفويون نقطة تحول تاريخية محورية. ففي عام 1501، أعلن الملك إسماعيل أن الإسلام الشيعي هو الدين الرسمي. ويرى العديد من المؤرخين أن دوافع الملك إسماعيل كانت سياسية في معظمها من أجل معارضة خصم فارس اللدود، الدولة العثمانية السنية.
أدى تحول الدولة الصفوية إلى المذهب الشيعي إلى عداء عميق لدى دول الجوار العربي السني تجاه بلاد فارس، مما ساعد فارس بدورها على بناء هوية قومية، وحكومة مركزية قوية، وترسيخ شكوكها تجاه الأقليات التي توارثتها الأجيال عبر القرون.
كما ساعد هذا التحول المذهبي إيران على أن تصبح الدولة التي هي عليها، ويساهم في التوترات في لبنان والحروب في اليمن وسوريا، وكان عاملاً في الصدام بين إيران والمملكة العربية السعودية منذ الثورة الإيرانية عام 1979. هذا لا يعني أنه يمكن استبعاد التنافسات السياسية بين الدول في هذه الأحداث، ولكن الانقسام الديني كان أساسياً في تشكيل الهويات.
أُطيح بالصفويين عام 1722 وبعد سقوطهم، شهدت القرون التالية عودة دوامة الضعف الداخلي والتهديدات الخارجية. لم يمنع إعلان الحياد الفارسي في الحرب العالمية الأولى القوات البريطانية والألمانية والروسية والتركية من استخدامها ساحةً للمعارك. في أعقاب ذلك، انشغل الروس بثورتهم، وهُزم الألمان والعثمانيون، فبقي البريطانيون.
- في الحرب العالمية الأولى والثانية
اكتُشف النفط قبل الحرب، فضمن البريطانيون حصولهم على الحقوق الحصرية لاستخراجه من باطن الأرض وبيعه. وكما كتب ونستون تشرشل لاحقًا عن استغلال النفط الإيراني: «جلب لنا الحظ كنزًا من عالم الخيال يفوق أروع أحلامنا».
أسس الإنجليز شركة النفط الأنجلو-فارسية (التي عُرفت لاحقًا باسم شركة البترول البريطانية) عام 1909، واشترى البريطانيون الحصة الكبرى. بعد الحرب، كانت لندن تنوي تمامًا جعل بلاد فارس محمية بريطانية، لكن ضابطًا من لواء القوزاق الفارسي يسمى رضا خان، كان لديه أفكار أخرى. في عام 1921، زحف رضا خان إلى طهران على رأس 1200 جندي واستولى على السلطة فعليًا. في عام 1925، صوّت البرلمان الإيراني على خلع الشاه آنذاك (أحمد شاه قاجار)، وعُيّن رضا خان رضا شاه بهلوي.
كانت البلاد منهكة. قرون من سوء الإدارة جعلتها على شفا التفكك، ولذلك عندما وصل هذا العسكري إلى العاصمة، متحدثًا عن استعادة النفوذ الفارسي، استمع الناس إليه. كانت مهمته لإيران التي أُعيدت تسميتها حديثًا هي جرّها إلى القرن العشرين، فشرع في برنامج بناء شمل شبكة سكك حديدية عابرة للبلاد تربط بعض المدن الكبرى.
ومع ذلك، لم يسيطر رضا شاه بهلوي على شركة النفط الأنجلو-فارسية، وطالما سيطر البريطانيون عليها، كان لهم رأيٌ كبير في الشؤون الفارسية. بنى البريطانيون أكبر مصفاة في العالم في ميناء عبادان، ومنها تدفق النفط الرخيص للإمبراطورية البريطانية.
في هذه المحطة التاريخية المهمة غيرت فارس اسمها إلى إيران، في عام 1935 في محاولة لتمثيل الأقليات غير الفارسية في البلاد، والتي تُشكّل حوالي 40٪ من سكانها.
خلال الحرب العالمية الثانية، حاولت البلاد مجددًا البقاء على الحياد، لكنها وقعت مجددًا ضحية للقوى الخارجية. بذريعة تقديم شاه إيران دعما للنازية، غزا البريطانيون والسوفييت البلاد، وبعد إجباره على التنازل عن العرش في 1941، حققوا هدفهم المتمثل في تأمين حقول النفط، وبناء خط إمداد إلى روسيا. كان هو من بنى شبكة السكك الحديدية، فأرادوا التلاعب بها.
حلّ ابنه محمد رضا بهلوي، البالغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا، محلّ الشاه. في عام 1946، ومع رحيل القوات الأجنبية، شرع الشاب في محاولة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لكنه في السياسة الخارجية انحاز إلى البريطانيين والأمريكيين لترسيخ إيران كحليف في الحرب الباردة المتنامية.
- مناهضة الاستعمار وانقلاب على الديموقراطية
ثم هبت رياح مناهضة الاستعمار، وتحولت إلى عاصفة حول ما أصبح يُعرف الآن بشركة النفط الأنجلو-إيرانية. ازدادت المطالبات بتأميمها. وفي عام 1951، أصبح محمد مصدق، أحد أشد مؤيدي التأميم، رئيسًا للوزراء. وسرعان ما أُقرّ قانونٌ نتيجةً للوعد بأن تذهب أموال النفط الإيراني إلى إيران وحدها.
كان رد الفعل سريعًا. جُمِّدت الأصول الإيرانية في البنوك البريطانية، وحُجِبَت البضائع المتجهة إلى إيران، وسُحِبَ الفنيون من مصفاة عبادان. لكن دون جدوى: صمد الإيرانيون.
في عام 1953، أرسلت لندن وواشنطن جهاز المخابرات البريطاني (MI6) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) للمساعدة في تنظيم انقلاب عسكري، انطلق شرارته عندما حل مصدق البرلمان، عازمًا على الحكم بمراسيم، مُجردًا الشاه فعليًا من السلطة.
كثيرًا ما يُقال إن البريطانيين والأمريكيين أطاحوا بالديمقراطية الإيرانية؛ ومن الإنصاف القول إنهم ساعدوا الفصائل الإيرانية على الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا.
كانت الدوافع الأمريكية مدفوعة بمخاوف من أن تؤدي الفوضى في إيران إلى استيلاء الشيوعيين على السلطة؛ ولم تكن الأرباح البريطانية من النفط الإيراني على رأس قائمة أولوياتهم. عاد الشاه، الذي هرب إلى إيطاليا، وعاد كل شيء إلى ما يرام في العالم. إلا أنه لم يكن كذلك.
- مفترق طرق نحو الثورة الإسلامية
بدا الانقلاب للبعض ناجحًا، لكنه ألقى بظلاله الثقيلة. توقفت مسيرة الديمقراطية الإيرانية الناشئة مع دخول الشاه في دوامة من القمع المتزايد. وسرعان ما واجه معارضة من جميع الأطياف.
استشاطت الجماعات الدينية المحافظة غضبًا عندما منح غير المسلمين حق التصويت؛ وعمل الشيوعيون المدعومون من موسكو على تقويضه؛ وأرادت النخبة المثقفة الليبرالية الديمقراطية؛ وشعر القوميون بالإهانة.
أعاد الانقلاب تذكير الشعب بما حدث عندما خضعت البلاد للتأثير الخارجي. كانت نتيجة تأميم النفط زيادة في إيرادات الدولة، لكن القليل منها وصل إلى الجماهير. كان الانقلاب مفترق طرق في التاريخ الإيراني، وتسارعت وتيرة البلاد نحو ثورة 1979.